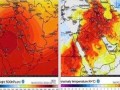الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
حرب استنزاف في الجزائر

بقلم : خيرالله خيرالله
عاجلا أم آجلا، سيظهر هل تستطيع الجزائر التقاط أنفاسها والبناء على ما تحقق منذ إجبار عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة، وقبل ذلك منعه من السعي إلى ولاية رئاسية خامسة. في الواقع، لم يكن بوتفليقة نفسه يريد هذه الولاية، بل كان يقف وراء هذا المسعى أفراد الحلقة الضيّقة التي كانت تحيط به، والتي كانت تدافع عن شبكة المصالح التي ارتبطت بها.
افتقدت هذه الحلقة الضيّقة كلّ أنواع المخيّلة. تبين مع مرور الوقت أنّها لم تكن تفهم طبيعة الشعب الجزائري، فضلا عن أنّه كانت تنقصها القدرة على إيجاد صيغة لمرحلة ما بعد عبدالعزيز بوتفليقة تضمن عدم ملاحقة أفرادها أمام القضاء. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّها لم تستطع استيعاب أنّها لم تدجّن المؤسسة العسكرية الجزائرية تماما، وأنّ النظام الذي صنعه هواري بومدين في العام 1965 ما زال حيّا يرزق. بل حيّا يرزق أكثر من اللزوم.
على غرار ما حصل في السودان، لعبت المؤسسة العسكرية الجزائرية دورها في التخلّص من تسلط المحيطين بعبدالعزيز بوتفليقة، وعلى رأسهم شقيقه الأصغر سعيد الذي اعتبر أن مجرّد بقاء الرئيس الجزائري على قيد الحياة يعني أنّ رئاسة الجمهورية في عهدة العائلة. بلغت الوقاحة بسعيد بوتفليقة أن وضع نفسه في موقع من سيختار الرئيس الذي سيخلف شقيقه الأكبر في حال وفاته قبل استكمال ولايته الخامسة. وكان هذا ما فشل فيه فشلا ذريعا. أدّى هذا الفشل إلى توقيفه بطريقة مذلّة في انتظار يوم يمثل فيه أمام القضاء.
حكمت الجزائر منذ وصول عبدالعزيز بوتفليقة إلى الرئاسة في العام 1999 شبكة من المصالح استطاعت السيطرة على مرافق الاقتصاد الوطني واستبعاد كلّ من يقف في طريقها بوسائل مختلفة. شمل ذلك ملاحقة القاضي الذي تابع قضية شكيب خليل والأشخاص الآخرين الذين كانوا يشكلون غطاء له في قضايا مرتبطة بمشاريع النفط والغاز التي ذهبت إلى شركات أوروبية معيّنة، خصوصا في إيطاليا. كان شكيب خليل وزيرا للنفط بين 1999 و2010 وكان أيضا رئيسا لشركة “سوناطراك” المسؤولة عن تسويق الغاز والنفط الجزائريين بين 2001 و2003. لُوحقَ خليل قضائيا وصدر حكم بإدانته. لكن القضية انتهت بإعادة المحاكمة وإبعاد القاضي الذي اصدر الحكم. شكل ذلك مثالا على مدى نفوذ أفراد الحلقة الضيّقة التي كانت تحكم باسم بوتفليقة منذ وصوله إلى الرئاسة. كذلك، كان إبعاد القاضي بنقله إلى مكان آخر أمثولة لكلّ من يتجرّأ على المسّ بمصالح مرتبطة بالحلقة الضيقة التي حكمت الجزائر في عهد بوتفليقة.
من الملفت أنّ المؤسسة العسكرية في الجزائر ما زالت تسيطر كلّيا على الوضع الأمني وعلى الانضباط في صفوف المنتمين إليها. لم يحصل ما حصل في السودان حيث أقدمت عناصر “غير منضبطة” على قتل نحو مئة مواطن في “ساحة الاعتصام” في ما سمّي يوم “الاثنين الدامي” (اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان). يبدو أن المؤسسة العسكرية الجزائرية تعلّمت من تجارب الماضي ومن “عشرية الرماد”. باتت تدرك أن ثمّة حدودا لا يمكن تجاوزها في حال أرادت البقاء لاعبا أساسيا في البلد. تحاول المؤسسة العسكرية الجزائرية لعب دور الحكم حاليا. أجبرت بوتفليقة على الاستقالة، لكهنّا فشلت في إجراء انتخابات رئاسية في اليوم الذي حددته لهذه الانتخابات. استجابت لمطالب الحراك الشعبي من دون أن تستجيب له. لن تكون هناك انتخابات رئاسية في الرابع من تمّوز/ يوليو المقبل واختار الرئيس الموقت عبدالقادر بن صالح الكلام عن ضرورة إجراء مثل هذه الانتخابات خلال فترة “مقبولة”. ما الذي يعنيه بكلمة “مقبولة” في وقت لا تزال المؤسسة العسكرية مصرّة على إيجاد طريقة لاستنساخ النظام الجزائري، نظام هواري بومدين، بطريقة لبقة. سلاحها في ذلك غياب القيادة السياسية في أوساط الحراك الشعبي الذي دخل ي
تخوض المؤسسة العسكرية الجزائرية حرب استنزاف للحراك الشعبي. ليس معروفا بعد هل سيحلّ اليأس مكان الأمل بتغيير النظام تغييرا كلّيا وجذريا في الجزائر؟ سيعتمد الكثير على قدرة الحراك الشعبي على إيجاد شخصيات تتحدّث باسمه، وتحدد طبيعة النظام الذي يُفترض أن يخلف نظام هواري بومدين الذي استطاع عبدالعزيز بوتفليقة تقمّص شخصيته، إلى حدّ ما طبعا، إلى حين تعرّضه لجلطة في الدماغ. حوّلته الجلطة إلى رجل مقعد غير قادر على الكلام بوضوح أو التوجّه إلى مواطنيه، بعد صيف العام 2013.
تحدّث عبدالعزيز بوتفليقة في العام 2012، عندما كان لا يزال يمتلك كلّ قواه الجسدية والعقلية، عن احتمال تخلّيه عن السلطة. قال، وقتذاك، بكل بساطة إن أيام الجيل الذي انتمي إليه “ولّت”. تحدّث مرات عدة عن ضرورة تسليم السلطة إلى جيل مختلف. لكن الواضح أن حاله الصحيّة لم تسعفه. استغلّ أفراد المجموعة الضيّقة المحيطة به تدهور حاله كي يعيدوا انتخابه لولاية رابعة. كان ذلك في العام 2014. كلّ ما يمكن قوله إن سعيد بوتفليقة ورفاقه حكموا الجزائر بين 2014 و2019 بشكل مطلق. استطاعوا حتّى التخلص من الجنرال محمّد مدين (توفيق) رجل البلاد القويّ في 2015.
كان مفترضا أن يحصل التغيير الذي مهّد له عبدالعزيز بوتفليقة في 2014. بقطع الطريق على التغيير، شرّع سعيد بوتفليقة ورفاقه الأبواب أمام المجهول. دفعوا ثمن لعبتهم تلك غاليا. الأكيد أن الثمن الكبير ستدفعه الجزائر التي لا يمكن أن تخرج من مأزقها في غياب القدرة على إيجاد قاسم مشترك بين المؤسسة العسكرية ممثلة بالجنرال أحمد قايد صالح من جهة، وقوى الحراك الشعبي من جهة أخرى.
مرّة أخرى، يمكن مقارنة الوضع الجزائري بالوضع السوداني. هناك في الوضعين حلقة مفقودة. يعود غياب هذه الحلقة إلى الهوة القائمة بين المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي. كما في السودان، لا وجود في الجزائر لشخصيات قادرة على ردم هذه الهوة تمهيدا للانتقال إلى نظام جديد يؤمّن الحد الأدنى من المطالب التي ينادي بها المتظاهرون في شوارع المدن المختلفة. ما يزيد في تعقيد الأوضاع في الجزائر والسودان غياب الإطار الذي يمكن أن يُبحثَ فيه موضوع الشكل الجديد للنظام في البلدين. ففي الجزائر، طرحت فكرة “الندوة الوطنية” التي سُحبت من التداول فجأة وذلك بعد إجبار بوتفليقة على تقديم استقالته. المشكلة أن لا بديل من هذه “الندوة الوطنية”، ولا بديل من الاستعانة مجددا بشخصيات تاريخية بقي لديها ما يكفي من رصيد لدى الجزائريين كي يطمئنوا إلى إمكان جسر الهوّة بين العسكر والمجتمع المدني تمهيدا لتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو معالم الفترة الانتقالية التي ستمهد لمثل هذه الانتخابات في ظل دستور جديد…
GMT 15:33 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير
شعر عربي اخترته للقارئGMT 15:29 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير
شعر المتنبي - ٢GMT 15:18 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير
من شعر المتنبي - ١GMT 23:58 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير
شعر جميل للمعري وأبو البراء الدمشقي وغيرهماGMT 21:18 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير
أقوال بين المزح والجديونس السكوري يكشف عن جهود الحكومة المغربية لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة
الرباط - المغرب اليوم
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، الجمعة بمجلس النواب، عن جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025. وأبرز السكوري، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة و...المزيدحاتم عمور يُؤكد أن ألبومه الجديد "غي فنان" عبارة عن مسلسل قصير كل حلقة فيه مستوحاة من المجتمع
الرباط - المغرب اليوم
طلق الفنان المغربي حاتم عمور، مساء السبت، أولى أغاني ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان "غي فنان"، على قناته الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات "يوتيوب".وطرح حاتم أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "بسيكولوج"...المزيدالاتحاد الأوروبي يُغرم شركة ميتا الأميركية بـ800 مليون دولار
واشنطن - المغرب اليوم
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797 مليون يورو (842 مليون دولار) على شركة "ميتا" الأمريكية، المالكة لـ"فيسبوك"، بسبب ممارسات مسيئة في متجر "فيسبوك" الإلكتروني "ماركت بليس".وأصدرت المفوضية الأور...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©