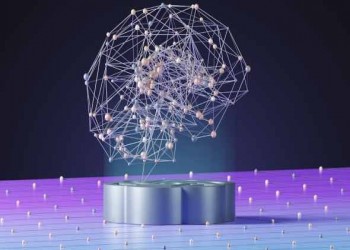الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
بغداد... «انقلاب 3 أيلول»

بقلم - مصطفى فحص
فتحت الجلسة الأولى المقتضبة للبرلمان العراقي الجديد، يوم الاثنين الفائت، سجالاً سياسياً داخلياً بين القوى العراقية المتصارعة على السلطة، وكشفت عن نوايا جدية لأطراف سياسية مؤثرة في الطلاق مع الماضي، وإمكانية الخلاص من تجربة فاشلة عمرها 15 سنة أدير فيها العراق بعقلية طائفية لم تُراع المصالح الوطنية.
تحت قبة البرلمان ظهرت ملامح انقلاب سياسي على كل التجربة الماضية بعدما نجح الثلاثي الشيعي العبادي والحكيم والصدر في تشكيل الكتلة الأكبر التي قطعت الطريق على مشاريع المحاصصة والاستحواذ الطائفي والمناطقي، ففي جلسة الثالث من سبتمبر (أيلول) أصبح من الممكن الرهان على تسويات وطنية تقلل من احتكار الكتل الشيعية لاختيار رئيس وزراء، ومن الممكن أيضاً أن تسمية رئيس الجمهورية لم تعد وظيفة الأكراد لوحدهم.
أما رئيس مجلس النواب السني فقد بات اختياره يمر عبر تحالف عابر للطوائف في إطار ما تتفق عليه مكونات الكتلة الأكبر التي من المفترض أن تمهد لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، تفرض عليها التطورات الإقليمية والدولية وضع مصالح العراق فوق كل اعتبار، وهو ما عبرّ عنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عشية انعقاد جلسة البرلمان، حيث قال: «لن نجازف بمصالح شعبنا إرضاء لإيران أو غير إيران».
رفض العبادي الصريح للتدخل الخارجي في شؤون العراق الداخلية، الذي عاد وكرره في خطابه أمام البرلمان، رسالة واضحة لطهران بأن عليها احترام قواعد الديمقراطية العراقية حتى لو كانت متعثرة، وأن تلتزم بمقتضيات حسن الجوار المحكوم بثوابت جغرافية وارتباطات عقائدية ودينية كانت تاريخياً سبباً مباشراً للصراع على العراق، وهذا ما يصعب على طهران تقبله، فليس من الوارد أن تتراجع طهران أمام صعود الوطنية الشيعية العراقية التي أيقنت أن تشيعها لا يصطدم بعروبتها، وأن مصلحتها في سيادة عراقية بعيدة عن الهيمنة تحت شعارات مذهبية، وأن علاقتها المتوازنة مع جوارها تضمن استقرار سلطتها، خصوصاً أن تجربة ما بعد 2003 أضرت بشيعة العراق أكثر مما أضرت بغيرهم، نتيجة الاستحواذ الإيراني على قرارهم السياسي، ومحاولة الهيمنة على موقعهم العقائدي، وهو تصرف مخالف للسياقات التاريخية التي بنيت على أساسها العلاقات الروحية ما بين العراق وإيران، والتي ساعدت في منح العراقيين تاريخياً فترات من الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبي.
ويعود الفضل في هذا الاستقرار إلى «معاهدة قصر شرين» المعروفة أيضاً بـ«اتفاقية زهاب»، ما بين العثمانيين والصفويين سنة 1639، التي أنهت صراعاً بينهما على العراق استمر أيضاً 15 سنة، حيث تنازلت الدولة العثمانية عن عاصمة أرمينيا يارفيان للصوفيين مقابل تنازل الأخيرة عن العراق، إلا أن السلطان مراد الرابع خان راعَى الروابط الروحية ما بين الإيرانيين الشيعة والأماكن الشيعية المقدسة في العراق، فمنحت التسوية حينها، التي أقرت بأن يكون العراق تحت سلطة العثمانيين سياسياً، دوراً اجتماعياً وعقائدياً للصفويين في العراق، الذين نجحوا نسبياً عبر داعيتهم منذ تلك الفترة في الربط ما بين الصفوية التوسعية والتشيع.
وقد استفادت إيران تاريخياً من العلاقة المتوترة ما بين سلطات بغداد والمرجعية النجفية التي تعرضت في عدة مراحل إلى حصار وإضعاف كانت إيران المستفيد الأول منه، حيث ساعدها حصار النجف في نقل جزئي للمرجعية الدينية الشيعية إلى قُم، ولكن مع سقوط نظام صدام استعادت النجف تأثيرها الذي أدى إلى تباين بينها وبين طهران حول كيفية إدارة شؤون العراق، حيث عارضت المرجعية النجفية الوصاية الإيرانية على العراق ما تسبب بفتور في العلاقة بينهما، هذا الفتور انعكس سلباً على علاقة طهران أيضاً بالثلاثي الشيعي العبادي والصدر والحكيم الذي أمنت له النجف غطاءً شرعياً لخياراته الداخلية والخارجية التي أزعجت طهران المصرة على الإهمال المتعمد للحساسية الشيعية العراقية، ودفاعها عن استقلالية هويتها الوطنية والعقائدية، ورفضها المطلق للاستحواذ الإيراني على العراق.
وعليه، فإن إيران التي حكمت وأدارت العراق من 2004 حتى 2014، ثم عادت وتقاسمت مع واشنطن حكمه، ولكنها حاولت التفرد بإدارته ما بين 2014 و2018، بدأ نفوذها يتراجع نتيجة حضور واشنطن الكثيف داخل مؤسسات الدولة العراقية، خصوصاً العسكرية والأمنية.
لقد باتت واشنطن تمارس دوراً يشبه دور إسطنبول ما بعد «اتفاقية زهاب»، فيما يستعد الثلاثي الشيعي لاستكمال عملية انقلابه التي بدأها في الثالث من سبتمبر، التي بدأت في تشكيل الكتلة الأكبر التي تحولت سياسياً إلى الصفعة الأكبر لطهران في العراق منذ 2003، حيث من الصعب التكهن بحجم ردة الفعل الإيرانية الانتقامية على هذه الصفعة.
GMT 14:15 2024 الأربعاء ,15 أيار / مايو
في ذكرى النكبة..”إسرائيل تلفظ أنفاسها”!GMT 12:08 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
مشعل الكويت وأملهاGMT 12:02 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
بقاء السوريين في لبنان... ومشروع الفتنةGMT 11:53 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
“النطنطة” بين الموالاة والمعارضة !GMT 11:48 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
نتنياهو و«حماس»... إدامة الصراع وتعميقه؟أخنوش يؤكد أن الحكومة المغربية تعمل حالياً بكل جهد من أجل خفض أسعار اللحوم
الرباط - المغرب اليوم
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في الدار البيضاء، إن مؤشرات التضخم شهدت تحسناً ملحوظاً، موضحاً أن هذا التحسن يتجسد في تراجع أسعار الخضروات. وأكد أن الحكومة تعمل حالياً بـ”قوة وجرأة” على خفض أسعار اللحوم في إطار ...المزيدالمغربية بسمة بوسيل تتحدث عن جوانب من حياتها الشخصية وتفاصيل عودتها إلى الغناء
الرباط - المغرب اليوم
تحدثت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن جوانب من حياتها الشخصية وأسرار لم يكشف عنها من قبل، وحول طلاقها من الفنان تامر حسني والد أبنائها، مؤكدة استمرار العلاقة الطيبة بينهما بعد الانفصال. وقالت بسمة بوسيل في تصريحات ...المزيددعوى قضائية شركة "Character.AI" لروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
واشنطن - المغرب اليوم
أقامت عائلتان دعوى قضائية في ولاية تكساس ضد شركة "Character.AI" لروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واتهمتاها بتقديم محتوى جنسي لطفليهما والتشجيع على إيذاء النفس والعنف.وطالبت الدعوى المحكمة بإغلاق من...المزيدوزير الأوقاف المغربي يؤكد أن العلماء المغاربة أنتجوا ملايين الوثائق لتوضيح براءة الإسلام من الإرهاب
الرباط - المغرب اليوم
ذكر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن "العلماء المغاربة قد أصدروا ملايين الوثائق" التي تهدف إلى تبديد المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، وخاصة تلك التي تروج لفكرة ارتباط الإرهاب بالإسلام. وأشار إلى...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©