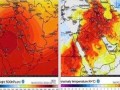الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
مائة عام شوكاً وياسمين

سمير عطا الله
بقلم : سمير عطا الله
نقل نزار قباني إمارة الشعر إلى سوريا بعدما راوحت بين مصر والعراق ولبنان. وفي النقلة حمّل الإمارة الكثير من الحداثة ورونق الصبا ومجاهرة الشباب، وأحدث لعبة فنية رائعة عندما صقل الأوزان ولطّف القافية. وإذا كان الشعر صناعة، كما قال الأقدمون، فقد أتقنها أيما إتقان، وإذا كان له ربة كما قال اليونان، أو إبليس، كما قال جرير، فقد استعار من كليهما.
في مئويته، هذا الشهر، لا يشيخ شاعر قرنفل دمشق، ولا يبهت شاعر «دفاتر النكسة». وقد صار منه شاعران: الأول شاعر «قالت لي السمراء» يوم أطل شاهراً سيف العطر، والثاني العام 1967. يوم أطل حاملاً سيف العار.
وسار الشاعران على درب واحد: الأول ينتقم لهزيمة المرأة، والثاني لهزيمة الأمة، وبينهما ظهر كاتب نثري مرير، يحذر الأجيال من تكرار الخمول والجهل والفشل. في هذه الأقلام الثلاثة التي حملها، كتب على إيقاع واحد: الفوران. مع المرأة وضدها. مع الثورة العربية وضدها. مع القضية الفلسطينية وضد الجميع.
وفي حياته الخاصة كان تماماً عكس صورته العامة. لا مجون، ولا جنون، ولا تهور، ولا بوهيمية الشعراء. بل عاش مثل أي بورجوازي دمشقي، كامل القيافة، كامل الاحترام، كثير الحسابات. لا مظاهر غنى ولا شكوى قلة. وكان يفضل أن يبيع كتبه بنفسه على أن يبيع شيئاً من نفسه. ومقابل الحرية الشعرية، التي مارسها بلا حدود، أصر على الأسلوب التقليدي المحافظ في تعامله مع الناس.
تنقل في ثلاثة مَنَافٍ، وعاش في وطن واحد: بيروت، وجنيف، ولندن. الوطن كان بحرة البيت في دمشق وفوقها عريشة الياسمين.
طابت له حماسة الجماهير ولم ينفِ مرة ضعفه أمام مشهدها على شجر الجامعة الأميركية في بيروت، أو تحت وطأة الرطوبة في البحرين. ولم يكن يخضع لممالق كاذب، أو يرد صداقة أصيلة. وكان مثقفاً ومنصفاً في إصدار الأحكام، ساخراً هازلاً هازئاً في عبوره بحار العناء ونوافل الشعر والنثر.
مضى قبل أن يشهد أفول الشعر ونضوب الشعراء. وكانت في استقباله دمشق، الغاضب منها، والعاتبة عليه. عاد من دون «بلقيس» التي ووري فتات جمالها في تفجيرات لبنان. كانت حبه الوحيد والألق، قصيدة من ألف امرأة، كانت مجرد مبارزة في الشعر بينه وبين إمارته.
GMT 22:05 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر
الكل متأخر... سيدي!GMT 15:33 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
لبنان يخشى "حزب الله"... بل يخشى إيران!GMT 15:30 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
متى يبدأ الدرس؟GMT 14:53 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
الانتخابات الأميركية واستحقاقات الحرب السريةGMT 14:50 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
لبنان... القول ما قالت «ندى» الجميلة!أخنوش يُؤكد أن صادرات المغرب تجاوزت 331 مليار درهم والتجارة الخارجية تتجه نحو التنوع
الرباط - المغرب اليوم
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إجمالية تقدر بــ 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة 5.3 في المئة، أي 16.8 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، مبرزاً أن...المزيدغوغل تُطلق مبادرة بـ15 مليون دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط
واشنطن - المغرب اليوم
تمثل مبادرة «فرص الذكاء الاصطناعي» التي أطلقتها «غوغل»، الخميس، إحدى الدعائم الرئيسية لواجهة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كونها أكبر برنامج لها يركز على الذكاء الاصطناعي في المنط...المزيدالدكتورة هبة القواس تتحدث عن حفلها الفني الثقافي الخيري "سمفونية الأمل" وتؤكد أنه من أجل الحب والخير
الرياض ـ المغرب اليوم
قبل لحظات قليلة من انطلاق الحدث الأبرز على المستوى الموسيقي والفني والثقافي والخيري في المملكة الذي تنظمه جمعية السلياك بعنوان "سمفونية الأمل"، أكدت د. هبة القواس أن العرض الموسيقي المنتظر تم إعداد...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©